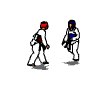إذا نظرنا إلى الموقع المحلي الجغرافي السياسي لما يُطلق عليه حالياً اسم سورية، لوجدنا أنها تمتد من البحر المتوسط غرباً إلى العراق شرقاً، ومن تركيا شمالاً إلى الأردن وفلسطين جنوباً، ولبنان في الغرب.
وضمن هذا الإطار العام تبلغ مساحة سورية الحالية 185ألف كم2. أما إذا نظرنا إلى امتداد سورية من خلال مقياس موقعها الفلكي على خريطة العالم، فهي تمتد على نحو خمس درجات عرض من 19 َ، 32° شمالاً تقريباً، وذلك من أقصى جنوب جبل العرب جنوباً إلى أقصى شمال شرقي الجزيرة شمالاَ، عند ملتقى الحدود الشمالية السورية-التركية مع نهر دجلة، كما تمتد على نحو ستٍ من درجات الطول من 43 َ، 35° شرق غرينتش.
ويغطي هذا الامتداد المسافة بين رأس ابن هاني على البحر المتوسط، ونقطة التقاء الحدود الشرقية السورية مع نهر دجلة.
لا يعبر موقع سورية عن أهميته العظيمة، إلا إذا نظرنا إليه من خلال أبعاده الكاملة الحقيقية، والمدى الذي بلغه خلال التاريخ في المجالين العربي والعالمي، إذ يكاد يكون هناك إجماع عالمي على أهميته. وقد برز ذلك بشكل واضح وجدّي في التاريخ المعاصر، بعد الحرب العالمية الأولى، عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية، التي كانت سورية قلبها النابض، وعندما حدثت المجابهة بين حركة الاستقلال والوحدة العربية، التي اتخذت من سورية مقراً لها، وبين الحلفاء الطامعين في تلك البقعة الخطيرة من العالم، والذين كانوا أيضاً على موعد مشبوه مع الحركة الصهيونية العالمية، لتحقيق تلك الأطماع. ففي ذلك الوقت، وفي صيف عام 1919 صدر تقرير لجنة «كنغ-كرين» الأميركية، يعبر عن الأفكار التي كانت سائدة آنذاك بالنسبة إلى أهمية موقع سورية، وقد ورد في ذلك التقرير ما يلي:
«لما كانت سورية جزءاً من رأس الجسر، الذي يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا ـ حيث يلتقي الشرق والغرب بصورة فريدة ـ فإن موقعها ذو أهمية إستراتيجية، وسياسية، وتجارية. كما أن له أهمية من زاوية الحضارة العالمية، لهذا يجب أن تتصف التسوية التي توضع لهذه المنطقة بالعدالة، بحيث تبقى على الأقل، ذات نتائج حسنة، لها صفة الاستمرار بالنسبة لقضية نمو حضارة خيّرة في العالم».
سورية من أغنى بلاد الأرض بتنوع الحضارات والأثار والأوابد مثلها مثل طبيعتها المتنوعة من الصحراء الى الجبال والسهول والبحر والأنهار، ومن هذه الأرض كانت بدايات الإنجازات الحضارية الكبرى، التي صنعها سكان هذه الأرض بجهدهم وتراكم خبراتهم، إنهم أجدادنا القدماء الصيادون الأوائل، وهم من الأوائل الذين عملوا بالزراعة وأسسوا المستوطنات الزراعية الأولى. وفي أوغاريت التي قدمت أول الألوان وأول مدونة موسيقية استطاعوا أيضا أن يقدموا للبشرية العطاء الأغلى وهو أول أبجدية عرفها الإنسان.
السفينة الفينيقية
ومن أوغاريت، أبحرَت السفن الفينيقية إلى قرطاجة وإلى العالم كله ناشرة الحضارة في كل أصقاع المعمورة.
وسورية أعطت روما بعضاً من أباطرتها مثل فيليب العربي وكركلا وإيلاغابال ونبغ فيها مشاهير تركوا بصماتهم الواضحة كالمعمار أبولودور الدمشقي صاحب عمود تراجان الشهير في روما، وباني جسر نهر الدانوب، ومن سورية كانت هندسة الكنائس البيزنطية تعتمد كمرجع في العمارة الكنسية في العالم كله، مثل كنيسة سمعان العمودي وكنيسةقلب لوزة وغيرها الكثير الكثير.
تعاقب على أرض سورية شعوب وحضارات عديدة: السومريون والعموريون والأكاديون والحثيون والفراعنة، والحوريون والآشوريون والكنعانيون والآراميون والفرس والإغريق والسلوقيون والبطالمة والرومان والعرب الأنباط، والبيزنطيون، والعرب الغساسنة، ثم كان الفتح العربي الإسلامي وتتالت عليها عصور الأمويين، العباسيين، الطولونيين، الإخشيديين، الفاطميين، وتعرضت الى حملات الفرنجة "الحملات الصليبية" المتعددة في عصور السلاجقة والأتابكة والدولة النورية والأيوبيين والمماليك كما تعرضت لغزوات المغول "التتار"، ثم حكمها العثمانيون حتى جاءت الثورة العربية الكبرى، ووضعت سورية بعدها تحت الإنتداب الفرنسي، إلى أن كان الجلاء عام 1946 حيث خرج آخر جندي محتل.
وآثار هذه الحضارات المتعاقبة الماثلة للعيان في يومنا هذا هي أقل بكثير من تلك التي ما زالت قابعة تحت تراب سورية تنتظر اكتشافها، فمن بقرص، وماري، ودورا أوروبوس، وأفاميا، وتدمر، والرصافة، وبصرى، وشهبا، والقلاع العديدة المنتشرة مثل قلعة شيزر، قلعة المضيق، قلعة صلاح الدين، قلعة المرقب، قلعة الحصن، قلعة جعبر، الى المعابد والمسارح والحمامات والكنائس والأديرة والفسيفساء والتماثيل والنقوش، وأقنية المياه، والمدافن والآثار الإسلامية من فجر الإسلام الى يومنا هذا، ففيها أنشئت أول مدرسة للطب، وأول بيمارستان، وطور علماؤها الفلك والهندسة والرياضيات، والطب والفلسفة وصناعة الساعات والاسطرلابات.
وتنتشر المساجد في أرجائها وكذلك المدارس والأضرحة والمزارات من الصحابة والأولياء والصالحين إلى الخلفاء والعظماء